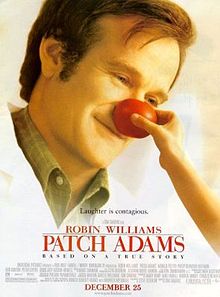فى هذا المقال (الثالث والأخير) أواصل حديثى معكم عن مفاتيح نجاح م/عثمان مستعرضة أهم المواقف التى أعجبتنى وأثرت فىّ.
ذكاء اجتماعى
المرونة… الاهتمام بمصالح الناس… التواضع لهم.. هذه بعض المواقف التى رأيت فيها هذه المهارات والسمات:
كان م/ عثمان يحرص على إقامة علاقات طيبة مع أهالى أى منطقة يذهب إليها، وعلى ترك أثر من روائه يفيدهم. ففى بداية حياته العملية كان يقوم بإعادة بناء كفر أحمد عبده بالسويس. وذهبت سياراته للمحجر لإحضار زلط، فمنعها أهالى المنطقة من الدخول بحجة أن سياراتهم فقط هى التى من حقها الدخول. وقف م/عثمان بجوار أهالى المنطقة. واتفق معهم على أن تقوم سياراتهم بالنقل ثم سألهم عن الحمولة التى تستطيع نقلها فى اليوم فوجدها نصف ما يريد، فسألهم هل يدبرون له وسيلة أم ينقلها بمعرفته، فاختاروا أن يدبر هو وسيلة النقل. وقام بتجديد سياراتهم على حسابه حتى أنهم خفضوا له ثمن النقلة دون أن يطلب منهم.
وأثناء عمل الشركة بمشروع السد العالى بأسوان مثلاً استخدم الحمير لنقل التراب من الموقع رغم وجود معدات حديثة بالموقع ليفيد أهالى المنطقة، وأقام هناك العديد من المرافق العامة. كما أنشأ معهد تدريب “المقاولون العرب” لتدريب العاملين فى مختلف المهن لأن احتياجات العمل من العمالة المدربة كانت كبيرة وفى نفس الوقت غير متواجدة. ونتيجة لهذا، قدّم أهالى المنطقة للمهندس/ عثمان مساكنهم الخاصة للعاملين فى المشروع حتى يبنى لهم مساكنهم.
أما بالنسبة للعاملين بالمشروع، فقد وفر لهم وسائل ترفيه (نوادٍ، دور سينما… الخ)، ووسائل مواصلات تنقلهم من وإلى موقع العمل، ومساكن للمتزوجين، ومطعماً يعمل كل اليوم بلا توقف يجد فيه العامل ثلاث وجبات مجانية يومياً، وترمس شاى لكل سائق لكى يشرب الشاى كلما أراد دون أن يضيع الوقت بحثاً عن كوب شاى. كما أقام بالشركة جمعية تعاونية استهلاكية مهمتها إرسال مندوب لبيت كل عامل وملاحظ ومهندس يسأل عن احتياجات بيته – لا فقط من المواد الغذائية وإنما كل السلع حتى الكراريس وأقلام الرصاص – ويقوم بإحضارها.
كما كان يهتم بالعلاقات بين العاملين، وبلغ به ذلك الاهتمام أنه كان عندما يجد بوادر عدم انسجام بين العاملين، ينتقل إلى الموقع ليقوم بتصفية سوء التفاهم وإعادة الود بينهم، ولم يكن يلجأ فوراً إلى الجزاءات بل يحل المشكلة من جذورها. وكان يشعر بعدم الانسجام هذا دون أن يخبره أحد، من خلال متابعة معدلات الأداء والتنفيذ، فكان يجد الخلافات تقلل من هذه المعدلات والانسجام يزيدها.
احترامه للعمال أيضاً وتواضعه لهم من العوامل التى عادت عليه بالكثير من الفوائد، فمثلاً يشرب الشاى مع السائقين ويأكل معهم فيزيد عدد الحمولات التى ينقلها السائق فى اليوم دون دفع أى زيادة إلا التودد إليه. ليس هذا فحسب بل ساعده ذلك ذات مرة فى حل مشكلة كبيرة كانت تواجه العمل حيث كانت السيارة (الروسية الصنع) وهى تفرغ حمولتها فى عرض النهر تهوى إلى الخلف وتقع من فوق حافة النهر، فجاء عامل بالحل. حاولوا منعه من مقابلة م/ عثمان الذى أراد مقابلته وسمع منه الحل وسمح له بتجربته. وفعلا نجح ولم تتكرر هذه الحادثة أبداً.
التفكير الإبداعى والمرونة والاستفادة من إمكانيات البيئة ظهرت فى مشروع السد العالى حين واجهت العمل عدة مشكلات منها سكن العمال. وقد وجد م/ عثمان حلها فى سبايت البوص الصعيدى من مخلفات عيدان الذرة الرفيعة التى تنتشر زراعاتها هناك. يقول: “كنت أبحث عن حلول سريعة للمشاكل لتؤدى الأغراض المطلوبة ثم أعود لأبحث عن الحلول الأفضل فى جو أكثر هدوءاً”.
م/عثمان وزيراً للإسكان ونقيباً للمهندسين
عندما كان وزيراً للإسكان فى عهد السادات، وفى أحد المؤتمرات وقف أحد المواطنين يشكو أنه منذ ثلاثة أشهر يسعى فى دواوين الحكومة حتى تصرف له التعويض عن بيته الذى انهار، مع أن الدولة هى التى قررته له. فحص م/عثمان الأمر فى نفس المؤتمر، حيث سأل عن الخطوات اللازمة من أجل صرف التعويض وعرفها، وحسب الوقت اللازم لكل خطوة فوجد إجمالى الوقت المطلوب ساعتين بعد أن كان ثلاثة أشهر! فأصدر قراراً فى نفس المؤتمر ألا تتعدى المدة التى يتم فيها صرف مستحقات أى مواطن أربعاً وعشرين ساعة فقط.
فى انتخابات نقابة المهندسين: رشح نفسه بناء على مطالبة ثلاثة آلاف مهندس له بالترشح لمنصب النقيب. وفى يوم الانتخابات جاء الآلافات ليدلوا بأصواتهم (أكثر من العدد المعتاد) لدرجة أنه طلب منهم الرجوع لأن الصناديق لا تكفى فأدلى ثمانية آلاف منهم فقط بأصواتهم، فاز م/عثمان منهم بسبعة آلاف صوت. وفى عهد توليه النقابة، جعل اجتماع المجلس الأعلى للنقابة كل مرة فى محافظة مختلفة، كما زاد عدد من يدفعون الاشتراك من ثلاثة وعشرين ألفاً إلى مائة ألف عضو.
مواقف إنسانية
أثناء عمله بالسعودية، جاء إلى م/ عثمان صبىٌ فى الثالثة عشرة من عمره، يدعى “متعب”، يريد أن ينضم إلى ورشه ليتعلم قيادة سيارة لورى، وظل يعمل معه حتى أصبح شاباً. وعندما قام م/عثمان بتصفية أعماله فى السعودية أراد “متعب” مرافقته إلى مصر، ولكن م/ عثمان رأى أن بلده أولى به. مرت السنون وكبر “متعب” وأصبح من رجال الأعمال فى بلده. وذات يوم فوجئ به م/ عثمان فى مصر جاء خصيصاً لزيارته وليس لأى أغراض أخرى.
أثناء قيام الشركة بمشروع فى مدرسة البنات الابتدائية بالإسماعيلية، أسند م/ عثمان عملية تركيب البلاط إلى عامل متخصص وماهر اسمه “عبد العزيز”، لكن كان عيبه أنه يبدأ فى العمل ثم يتركه قبل أن يكمله ويبدأ فى عمل آخر وذلك حتى “يربط الزبون”. وفعلا أخذ “عبد العزيز” جزءاً من المال واشتغل ثلاثة أيام ثم اختفى شهرين. وفى أحد الأيام فى الساعة السادسة صباحاً، وجده م/ عثمان أمامه وهو خارج من بيته، فسلم عليه بحرارة وسأله عن صحته وأولاده ولم يكلمه فى المشروع، وكان “عبد العزيز” فى أشد الحاجة إلى سبعمائة جنيه، فأعطاها له قائلاً: تحت أمرك فى أى مبلغ. وبعد ثلاثة أيام فوجئ م/عثمان بعبد العزيز فى الموقع يقوم بتركيب البلاط دون موعد، ومعه خمسة عشر عاملاً – بعد أن كانوا من قبل أربعة فقط – حتى يعوضه التأخير. ورفض “عبد العزيز” أن يتقاضى أى أجر حتى ينهى عمله تماماً.
ذات يوم استلم م/ عثمان خطاباً من سيدة مصرية بسيطة ومعه شيك باسمه بمبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة جنيه (3700). لقد استشهد ابن هذه السيدة فى حرب أكتوبر وتقاضت هذا المبلغ من الدولة كتعويض. وأرادت أن تبنى بهذا المبلغ مسجداً باسم ابنها الشهيد، ولهذا أرسلت بالشيك للمهندس عثمان قائلة أنها سمعت عنه أنه رجل طيب فلم تستأمن غيره رغم أنها لا تعرفه معرفة شخصية.
وبهذا انتهت الرحلة التى بدأناها بين صفحات كتاب “صفحات من تجربتى”